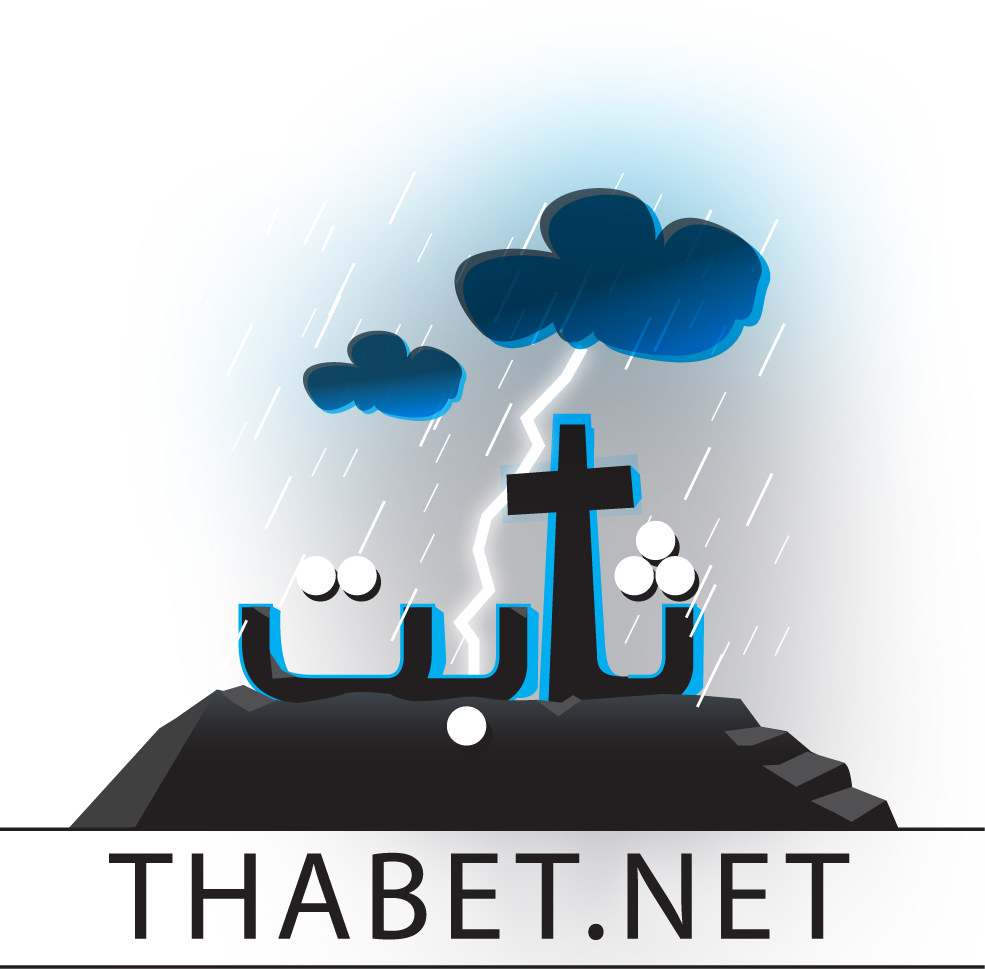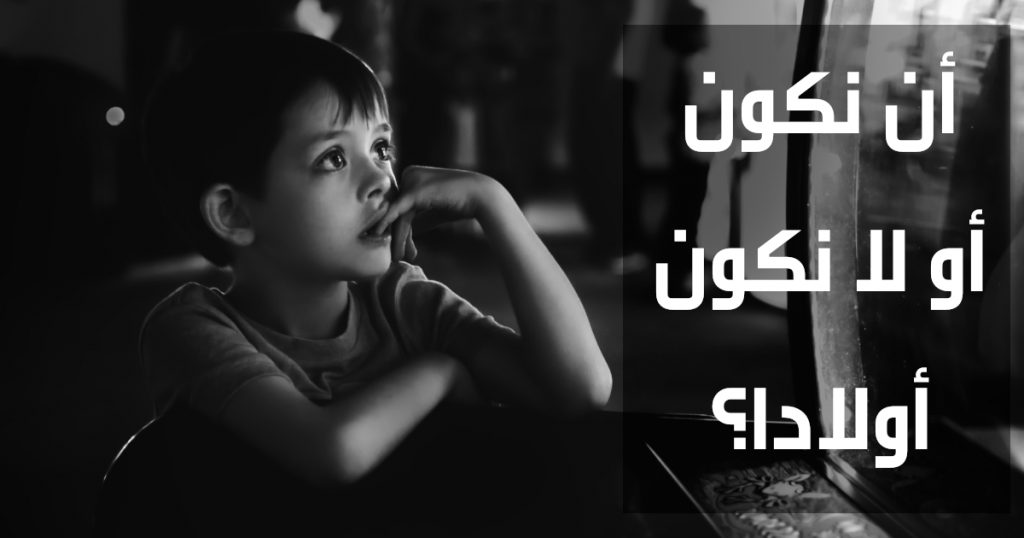قد يبدو للبعض أن هنالك نوعًا من التناقض بين العقلانيّة والإيمان، إذ أن الإنسان العقلاني يتبع العلم والمنطق، التجارب والأدلة، يُفعّل عقله النقدي ويشكّك، يطرح عدة نظريات ويستكشف أفضلها. وأمّا المؤمن فمن المفروض أن يكون لديه العقيدة الواحدة التي يصدّقها، يضع ثقته بشيء غير ملموس، ويطيع وصايا بشكل قد يبدو أعمى.
إضافة إلى ذلك، يستخدم البعض آيات من الكتاب المقدس التي تزيد للوهلة الأولى، من الهوّة بين الإيمان والعقلانية. مثلا، يقال إنه على المؤمن ألا يعتمد على فهمه (أم 3: 5)، وأن يخاف من أن يفسد المكر الأذهان عن البساطة التي في المسيح (2 كو 11: 3)، وأن العلم ينفُخ (1 كو 8: 1) وأن علينا أن نرجع ونصير مثل الأولاد كي ندخل ملكوت السموات (مت 18: 3).
من خلال نظرة سريعة لسياق هذه الآيات التي ذُكرت، نرى أنها لا تمت بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، بردع المؤمن من استخدام عقله. فالحكيم، كاتب سفر الأمثال، يدعونا ألّا نكون حكماء بأعين أنفسنا، والا نعتمد على فهمنا دون أن نتوكل على الله. ونلاحظ أنه يحثنا على تفعيل العقل مرارًا وتكرارًا، فمثلا يقول: “إذا دخلت الحكمة قلبك ولذّت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك” (أم 2: 10-11) [1]. وبالنسبة للانتفاخ من العلم فسببه عدم محبة هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون هذه المعرفة [2]. البساطة في المسيح تفسد بحسب السياق، عندما نُخدع من الحيّة، وليس عندما نفكّر. وماذا عن “ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد”؟ هذا لا يعني ألا نفكّر، فالأولاد هم الأكثر حبًّا للاستطلاع واستعدادًا للتعلم.
ليس ذلك وحسب، بل إن هنالك قائمة طويلة من الآيات التي تحثّنا على تفعيل تفكيرنا النقدي. لا يسعني هنا إلّا أن أذكر بعضًا منها. تقع على رأس هذه القائمة الوصيّة العظمى، إذ يقول السيد المسيح أنه يجب أن نحب الله بكل فكرنا وليس بقلبنا فقط (مت 22: 37). ويشجعنا بولس الرسول على ألا نكون أولادًا في أذهاننا، بل في الأذهان علينا أن نكون كاملين (1 كو 14: 2). ويمدح لوقا أهل مدينة بيرية لأنهم كانوا فاحصين الكتب كل يوم (اع 17: 11). لكن أكثر الأمثلة وضوحًا هي التي تتكلم بشكل عام عن صورة الله التي تشمل الحكمة والمعرفة والمنطق، فهو العقل المدبّر العظيم وراء هذا الكون الرّهيب. ويصف يوحنا الرسول المسيح بالكلمة، التي هي باليونانية لوجوس، وهي من نفس جذر (Logic) أي منطق، والله الكائن كليّ المعرفة والحكمة، خلق الإنسان على صورته (تك 1: 27).لن أعدّد هنا جميع مخاطر هذا النوع من الإيمان الذي يقلل من شأن الفكر، لكن أهمّ هذه المخاطر، إنه لا يطابق تعليم الكتاب المقدس [3]. إنه إيمان يُعرّض الشخص أن يكون محمولا بكل ريح تعليم (اف 4: 14). لقد ظهرت في بداية الكنيسة هرطقات كثيرة، ونرى آباء الكنيسة يقفون لها بالمرصاد ويستأسرون كل فكر لطاعة المسيح (2 كو 10: 5). دون عقل مسيحيّ ناضج، وذهن متجدد مستعد للامتحان والفحص، يَسهُل على الإنسان أن يقع فريسة لمذهب غير كتابي، ومن المحتمل أن ينتقل حتى إلى اعتناق إنجيل آخر (غل 1: 6).
تعريف الإيمان
ربما تكون إحدى النقاط المحوريّة لحل هذا التوتّر بين الإيمان والعقلانية هي تعريف الإيمان. هل الإيمان يعني تصديق كل شيء؟ هل يعني تبنّي معتقدات دون فحصها أو النظر إلى الأدلة التي تدعم صحتها؟ أظن أن هذا تعريف سيء. فهل أنت كمسيحي مستعد أن تؤمن بوجود ديناصور حي بغرفتك الآن؟ هل تؤمن بأن الله غير موجود؟ طبعًا لا! إذا، ماذا يعني أن أؤمن بشيء ما؟ كلمة الإيمان بالعربية تحوي عدّة معاني. ويساعدنا التعمق بهذه المعاني على الإجابة عن هذه التساؤلات. يعني المعنى الأول للإيمان-التصديق أو الاعتقاد. مثلا عندما نقول: “أنا أومن أن يسوع المسيح مات على الصليب”. تعني هذه الجملة أني أعتقد أو أصدّق أن هذا الحدث، موت يسوع المسيح على الصليب، قد حصل فعلا. ومن الجهة الأخرى، هنالك اختلاف بين “أؤمن أن” وَ “أؤمن بِـ”. مثلا عندما أقول: “أنا أؤمن بالمسيح الذي مات على الصليب”، لا تدَعي هذه الجملة فقط أني أصدّق حقيقة حدث موت يسوع على الصليب فحسب، بل هنالك بُعد أعمق. ويتكلم الكتاب المقدس عن هذا البعد في الكثير من استخداماته لكلمة إيمان. والكلمة باليونانية للإيمان هي “pistis” والتي تحمل في معناها معنى الثقة أيضا. بناء على هذا المفهوم وعلى آيات كثيرة (مثل عبرانيين 11: 1) يقول اللاهوتي والفيلسوف وليم لين كريج: “إن الإيمان ليس وسيلة للمعرفة”. قد يظن البعض أن المنطق والعقل يقودانا لمرحلة معينة، ومن ثم نعتمد على الإيمان لكي نعرف أن الله موجود. لكن هذا سوء فهم للإيمان كما ورد بالكتاب المقدس. ثمّ يعرّف كريج الإيمان ويقول: “الإيمان هو الثقة التي نضعها بشيء، عندما نعتقد أنه صحيح” [4].
وبناء على مفهوم الإيمان كثقة، أنا فعلا أريد أن أكون ولدًا! أريد أن أثق بالله تماما كما يثق بي أولادي وأكثر. أنا أحبّ أولادي وأعرف مصلحتهم. هم اقتنعوا بمحبتي لهم، ووثقوا فيّ. يشجعني هذا أن أصلّي، كي تزداد ثقتي في الله. وتشمل هذه الثقة الاتّكال والاعتماد، وهي من أساسيات العلاقة مع الله والحياة المسيحيّة. عندما نؤمن بشيء معين، ليس فقط نوافق عليه، بل نتبنّاه، ونكون على استعداد أن نعيش حياتنا بحسبه، وكأننا نربط مصيرنا به.
هنالك حالات كثيرة يقتنع الناس فيها بصحة أمر معين، لكنهم لا يعيشون حياتهم بحسبه. ويعطي وليم لين كريج مثالا جميلا يوضّح به الموضوع [5]. كان على كريج قبل عدة سنوات، أن يخضع لعملية زراعة قرنية في عينيه. فابتدأ بالبحث عن أفضل الأطباء المختصين في المجال، وتوصّل لاقتناع كامل أنه وجد الطبيب المطلوب. ولكن هل اقتناعه كاف للعلاج؟ كلا! إنه بحاجة أن يثق بالطبيب وأن يسلّم نفسه له، ويضع عينيه تحت مشرطه. وكذلك الأمر بالنسبة للإيمان المسيحي. يدّعي العديد من الأشخاص أنهم يصدقون الكثير من العقائد المسيحيّة مثل وجود الله ومحبته، وصلب وقيامة المسيح، وذلك مجرّد موافقة فكرية. لكن هل فعلا كل من صدّق ذلك يعيش حياته بحسب تعاليم المسيح؟ هنالك حاجة لخطوة أعمق من مجرد الاقتناع. من أجمل التعابير عن هذا البعد الأعمق، هي فكرة الإتحاد بالمسيح، كما يعبّر عنه بولس بصرخته الشهيرة: “مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيّ” (غل 2: 20). نعم، إن إحدى أبعاد هذا الإيمان، هو القرار بأن نعيش ونلتزم بعلاقة حيّة بالمسيح، نثق به ونتّكل على صدق تعاليمه.
نمو الأذهان
السؤال الذي يُطرح أمامنا الآن: كيف يَعرِف الذهن ما هو صحيح؟ كيف يفحص ذلك؟ متى أستطيع أن أقول: “أنا أعتقد أن ذلك صحيح” ولماذا؟ هذا موضوع هام جدا يتعلّق بعلم المعرفة (epistemology)، ويستحيل علينا تغطيته هنا. ولكن نستطيع أن نقول باختصار، هنالك وسائل كثيرة للمعرفة، منها: العلوم الطبيعية، والمنطق، والخبرات الشخصية، وخبرات الآخرين، والتاريخ وغير ذلك. وبالنسبة للمؤمن هنالك وسائل معرفة أساسية أخرى وهي كلمة الله، وتفسيرات المؤمنين للكلمة، وروح الله الساكن فينا، وروح الله الساكن في إخوتي الآخرين، وغيرها. وكما رأينا سابقا، لا يريد الله أن نكون أولادًا في أذهاننا، بل يريد أن ننمو وأن نكون كاملين في الأذهان (1 كو 14: 2). أي أنه علينا ألا نُبقي أذهاننا كذهن ولد صغير، فأيّ أب منّا يريد أن ينمو أولاده جسديًا، وتبقى أذهانهم مثل ذهن الطفل؟ إن الله، الآب السماوي، يريد أن تنضج أذهان أولاده، لتتعلم كيف تعرف الحق وتنمو به. إحدى الطرق للنمو هي فحص ما هو صحيح، وامتحان صدق المعتقدات والأفكار.
من أهم جوانب النمو الذهني المسيحي الصحيّ، هو تبني معتقدات صحيحة. ومن جانب آخر، إن من سمات الإيمان الناضج، القدرة على تمييز المعتقدات الخاطئة. ورغم أن هذه المعتقدات الخاطئة موجودة لدينا جميعنا، لكنها مزيّفة وتبعدنا عن الحق. حارب الرسول بولس في رسائله العديد من المعتقدات الخاطئة التي تسللت إلى الكنائس في تلك الفترة. مثلا، فقد كان هناك في كنيسة كورنثوس، من أنكر القيامة من الأموات، وفي رسالته إليهم (1 كور 15) نرى بولس يحاول النقاش لكي يقنعهم بتاريخيّة ومنطقية القيامة. إن الاجتهاد والدّراسة مهمّان لتصحيح المعتقدات الخاطئة، لكن دعونا لا ننسى أن التصحيح يبدأ بالتواضع والاعتراف بأننا قد نكون مخطئين، ومن خلال الصلاة مع كاتب المزمور، نطلب من الله أن يمتحنّا ويعرف أفكارنا، ويهدينا طريقًا أبديًا (مزمور 139: 23 – 24).
في كتابه “تجديد القلب”، يقول الفيلسوف المسيحي دالاس ويلارد “أن أوّل حركةِ تمردٍ تقومُ بها قلوبنا بعيدًا عن الله تنبعُ من الفكر. لذا فإن أوّل حركةٍ للعودة إلى الله تبدأ من الفكر” [6] ومن هنا علينا أن نقوم بتغيير أذهاننا، وهذا بالفعل ما تعنيه كلمة التوبة باليونانية “تغيير الذهن”. ويُكمل ويلارد ويقول: إن الله يريد تغييرنا من خلال كلمته والروح القدس، ولذا يبدأ بِحَثِّ أرواحنا من خلال تحريكنا نحو الأفكار الصحيحة، لنعرف الحق والحق يحرّرنا. تؤثر أفكارنا عن الله وعن كلمته وعن الإنسان وعن الخليقة ككلّ كثيرًا على سلوكنا ومشاعرنا، لذا فهي عامل هام في تشكيل شهادتنا أمام الناس وقدرتنا في إنجاز إرساليتنا.
مستعدون للمجاوبة
يوجد للفكر أدوار كثيرة جدا في الحياة المسيحيّة الكنسيّة. يوجد له دور في الوعظ وتعليم الكتاب المقدس، وفي كتابة الترانيم وتلحينها، وفي الإرشاد والرّعاية، وفي الإدارة والتنسيق، وفي القيادة والتحفيز، وغيرها من الأمور. وقد واجهت الكنيسة على مرّ التاريخ هجوما فكريا شرسًا، وكان عليها كما قال الرسول بطرس، أن تكون مستعدة للمجاوبة (1 بط 3: 15). وقد يظن البعض، أن هذا الأسلوب الذي به مواجهة ومجاوبة، ليس في مصلحة الإنجيل. فالإنسان لا يستطيع أن يُقنع الآخر بصدق الرسالة المسيحيّة، إلّا أننا نرى حياة الرسل مليئة بالمحاجّة والإقناع، والجدال والمواجهة. ويفيض سفر أعمال الرسل بالأمثلة على ذلك (أع 13: 43، 17: 2، 18: 4، 18: 19، 19: 8-9، 26: 28، 28: 23). كان الرسول بولس على سبيل المثال في أفسس، يدخل المجمع ويجاهر لمدة ثلاثة أشهر، محاجًّا ومقنعًا فيما يختص بملكوت الله (أعمال 19: 8). كان يقوم بذلك ليس في يوم أو يومين، بل خلال ثلاثة أشهر كاملة، وقضى بعد ذلك سنتين يحاجّ في مدرسة تيرانس! لا يبدو لي أن بولس كان يخاف المناظرة أو المواجهة، بل كان يتقن فن الإقناع والبلاغة، إذ مكتوب عنه أنه كان يفحم معارضيه (أع 18: 28)!
أعتقد أن الرسل قد تعلّموا هذا من السيد المسيح نفسه، ومن خلال حواره بصورة كبيرة. فلقد حاول العديد من رجال الدين مرارًا وتكرارًا أن يمسكوه بكلمة لكي يسلّموه للحكم (لو 20: 20)، إلّا أنّه أسكتهم (لو 20: 26)! وكُتب في موضع آخر أنه قد أبْكمهم (مت 22: 34)، وهذا لم يحدث عن طريق التهديد والعنف أو الصراخ، بل عن طريق إجابات حكيمة، حتى أنهم لم يَجسروا أن يتابعوا معه المُساءلة (متى 22: 46).
رغم ذلك، أعتقد أن المجهود الفكري وحده، غير كافٍ للإيمان الحقيقي في المسيح، إذ أنّ الإيمان مبني على علاقة محبّة اختبارية مع الله. قد يسأل أحدهم: إذا، ما الفائدة من هذا الاجتهاد الفكري في المواجهة؟ أظن أن الشواهد أعلاه تبيّن لنا على الأقل أن الله قادر على استخدام هذا الأسلوب لمجده. لا يجب أن نحدّ الرب، فلديه طرق ووسائل عديدة ليُكلّم أرواحنا من خلالها. إن الفكر هو إحداها، وبالطبع ليس هو الطريقة الوحيدة. وأريد أن أعدد هنا بعض الأسباب التي قد تُشجعنا على أن نُفعّل هذا المجال الفكري في كنائسنا، بذكر أهم التأثيرات على من هم في داخل الكنيسة:
- يواجه العديد من المؤمنين شكوكا وتحديات فكريّة. وتساعد الإجابات المقنعة في عملية إطفاء نار هذه الشكوك، وقد وتحفّزهم على الالتزام أكثر بحياة الإيمان.
- عندما يسمع المؤمنون أجوبة مقنعة حول الأسئلة المطروحة، يشعرون بالشجاعة والحماس من أجل مشاركتها مع غيرهم، أو على الأقل يعرفون أن هنالك أجوبة لكي يرشدوا الآخرين لها.
من أهم التأثيرات على من هم خارج الكنيسة:
- تساعد الأجوبة المقنعة الشخص الذي يبحث عن الله في إزالة العقبات الفكريّة من طريق بحثه وتسهّله.
- يسخر بعض الأشخاص من الإيمان والمؤمنين علنا. ولقد شاهدت في العديد من الأحيان، أن هذه الأجوبة لم تقنعهم، لكنها أوقفت سخريتهم وتهجمهم أو خففتها على الأقل.
- يقول وليم لين كريج إن هذه الخدمة تُشكّل ثقافة [7] يكون الإيمان المسيحي فيها اختيارًا معقولًا منطقيًّا وعقلانيًّا، وليس كما يدّعي بعض الساخرين، أنه مجرد تصديق لقصة خياليّة.
العلم والإيمان
ربما تكون إحدى أكثر الاعتراضات انتشارًا في يومنا هذا، هو أن الإيمان يتناقض مع العلم. فلماذا يعتقد البعض ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال المهم، يجب أن نراجع تصريحات بعض من رجال الدّين والعلماء عبر التاريخ. لكن الأهمّ من هذا هو السؤال: هل يوجد تناقض مثل هذا حقًا؟ هل كلّما درسنا العلوم ودخلنا المختبرات وقمنا بالتجارب وحلّلنا النتائج، وخرجنا بنظريات أو قوانين جديدة، سوف يضعف إيماننا بوجود الله الخالق؟ ولماذا؟
يوجد عدد من العلماء [8] الذين نالوا شهرة عبر المواقع الإخبارية والاجتماعية، لأنهم يبشّرون بالإلحاد وينادون بهدم الدين وسلطته، ويتهجّمون على الكتب المقدسة بصورة ساخرة. كونهم علماء، ويتباهون بشهادات علميّة عالية، اعطى كلامهم مصداقية معيّنة حتى ان ّالبعض قد يظن أن كلامهم الفلسفيّ واللاهوتيّ (الخارج عن مجال اختصاصهم العلمي) أصبح أيضا مثبتًا علميًّا.
إن العديد من الأشخاص الذين يقتنعون بتوجه هؤلاء العلماء، يظنّون أنّ العلم هو الطريق الوحيد لمعرفة الحق، ويُسمى هذا التيار بالعلْمَوية (Scientism). ولكن، دعونا نتفحّص هذه الكلام نفسه. هل جملة “العلم هو الطريق الوحيد لمعرفة الحق” هي جملة علميّة؟ كلا إنها ليست كذلك! إنها اعتقاد فلسفيّ دون أي دعم علمي. ولنعطي مثالا على جملة علمية: “سقوط التفاحة عن الشجرة يكون دائما إلى الأسفل باتجاه الأرض، وذلك بسبب قانون الجاذبيّة”. نرى في هذا المثال حدثًا معيّنًا وتفسيرًا علميًّا له. أمّا جملة: “العلم هو الطريق الوحيد لمعرفة الحق”، هي افتراض فلسفيٌّ دون تفسير أو دليل علمي من أجل إثبات مصداقيته. ولذلك، هذه الجملة غير علميّة، وهي بحسب فحواها لا تقودنا لمعرفة الحق. يوجد هنالك بكل بساطة طرق أخرى لمعرفة الحق، مثل التاريخ والمنطق والاختبار الشخصي وغيرها. وبناء على ذلك، لا يملك “العلم” الطريق الحصري لمعرفة الحق.
ويعتقد بعض الملحدين الآخرين، أنّ العلم والإيمان بوجود الله لا يتماشيان سوية، ويضع هذا الاعتقاد الإنسان تحت الأمر الواقع، فإمّا أن يختار العلم أو الإيمان! هذا “التخيير” مثال رائع لمغالطة منطقيّة معروفة باسم “معضلة زائفة”. (False Dilemma)، لأن الحقيقة هي أن الاختيارين المطروحين ليسا الوحيدين، بل هنالك اختيارات أخرى. أعطى بروفيسور الرياضيات جون لينوكس من جامعة أوكسفورد البريطانية مثالا يوضّح هذه المغالطة [9]، وسنقوم بعرضه عن طريق السؤال الآتي: ما هو أفضل تفسير لاختراع السيّارة: هنري فورد (مخترع السيارة الأولى في العالم) أم قوانين الاحتراق والديناميكا؟ إن الإجابة ليست محصورة بأحد هذين التفسيرين فقط، بل الاثنين معًا، إذ إن أحدهما لا يلغي الآخر. إذا، لماذا علينا أن نختار إمّا العلم أو الإيمان؟ ألا يمكن أن يتماشيا معًا؟
يعتبر جون لينوكس مثالا لعالِم مؤمن، ويوجد مثله العديد من العلماء المؤمنين في عصرنا هذا: أمثال أنطوني هيويش ووليم دانيل فيليبس، وكلاهما حائز على جائزة نوبل في الفيزياء، إضافة إلى العالم فرانسيس كولينز الذي يترأس في يومنا هذا المعهد الطبيّ الوطنيّ في أمريكا، وهو المسؤول الرئيس عن الأبحاث في الأدوية وغيرها. لا يسعني الوقت لكي أقوم بذكر عمالقة العلماء المؤمنين الذين يشهد لهم التاريخ، والذين أسسوا المنهج العلمي، أمثال إسحاق نيوتن، وجاليليو جاليلي، وجوهانس كيبلر، ونيقولاس كبرنكوس، وغيرهم. لم ير أحدهم أن عليه ترك إيمانه، عندما زادت معرفته العلميّة، بل سار الإيمان والعلم معًا.
لقد أدرك جميع هؤلاء أنّ العلم يدرس العالم الماديّ، خليقة الله، وكلّما درسوا العالم أكثر، اكتشفوا عظمة الله أكثر فأكثر، فمجّدوه وسبّحوه على نعمة العقل والتفكير والبحث، فمن خلال كتاب الخليقة (الطبيعة)، تعرّفوا على جزء من مجد الخالق. إن العلم لا يمكنه أن يناقض وجود الله، فالعلم يدرس المادة، وأمّا الله فهو روح (لا مادّي). ثمّ كيف يمكن أن تناقض لوحة الرسم وجود الرسّام، أو كيف للجبلة أن تناقض وجود جابلها؟ لكن، ربما إذا نظرنا إلى لوحة الرسم بدقّة، لوجدنا إشارات أو أدلّة على وجود الرسّام وطبيعته.
هل حدوث العجائب أمر عقلاني؟
لو تقبّلنا التناغم بين العلم والإيمان، يبقى السؤال: كيف للعجائب أن تكون مقبولة للإنسان العقلاني؟ كيف يمكن لعالِم أن يؤمن بها؟ هل حقّا تتوقع منه الإيمان بعذراء تحبل، أو السير على الماء أو القيامة من بين الأموات! للإجابة على هذا السؤال، من الجيّد أن نوضّح الفرق بين العقلانية وبين الأحداث الطبيعية. عندما نقول عقلاني، نقصد أن لدينا أدلّة منطقيّة وفلسفيّة، تاريخيّة اختباريّة أو غيرها على صحّة الشيء. أمّا الحدث الطبيعي فهو ما يدور في الطبيعية من حولنا بشكل عام، تحت سيادة القوانين الفيزيائيّة، أي بالأحرى بدون تدخلات فوق طبيعيّة. فإن سألنا هل من الطبيعيّ أن يمشي إنسان على الماء، سيكون الجواب طبعا لا، لأن قوانين الفيزياء تُحتّم استحالة ذلك. لكن من يؤمن بالعجائب، لا يؤمن أنها أمر طبيعي، بل يؤمن بأنها تدخّل فوق طبيعيّ في الطّبيعة. إن النقطة المهمة هنا، هي أن كون العجائب غير طبيعيّة لا يعني أنها غير منطقية.
أعلن الفيلسوف الأسكتلندي المُشكك ديفد هيوم، أن العجائب فيها كسر لقوانين الطبيعة، لذا فهي غير معقولة [10]. ولقد قام الملحد البريطاني السابق، البروفيسور من أوكسفورد سي اس لويس، بالإجابة بمثلٍ جميل [11]، قال: إن وضعت في الدرج 2000 باوند، ووضعت في اليوم التالي 2000 باوند مرة أخرى. ثم فحصت في اليوم الثالث الدرج ووجدت أن الموجود هو 1000 باوند فقط، لا نقول أن قوانين الرياضيات قد انكسرت، بل قوانين بريطانيا، أي أن أحدهم تدخّل وفتح الدرج وسرق النقود منه.
السؤال المطروح هنا، هل تدخل في الطبيعة مثل هذا يمكن أن يُعدّ عقلانيا؟ إن كان العالم الماديّ هو كل ما هو موجود، ولا يوجد إله، أي أن الطبيعة هي كل شيء، لا يمكن أن يتدخل أي شيء فيها، وعندها يصبح الإيمان بالعجائب غير منطقي. لكن إذا كان الله موجودا، وهو كليّ القدرة، لا توجد استحالة منطقيّة لتدخله في خليقته. إن قوانين الطبيعة في حدث كالمشي فوق الماء، تدفع بالإنسان لكي ينزل تحت الماء، ولكن إذا أراد الله، الذي خلق العالَم بكلمة، فإنه قادر على الإمساك بالإنسان كي لا يغرق. هل تُكسر قوانين الطبيعة، إذا أمسكت أنا بيد ابني الصغير وأمشيتُه على الماء؟ كلا! كل ما هنالك أني أضفت قوة أخرى على المعادلة الفيزيائية. إن كان الله موجودًا، من سيمنعه من التدخل لصنع شيء شبيه؟
ويبقى السؤال: هل وجود الله أمر عقلاني؟ يسعدني أن أبشركم بأننا نعيش في هذا الزمان فترة من النهضة والانتعاش في موضوع فلسفة الدّين، والذي يختص في مجال الأدلة على وجود الله. عدد كبير من الإصدارات الأكاديميّة قد نشر في الستين سنة الأخيرة. ولقد قام الفلاسفة المسيحيون وما زالوا، بخدمة مقدسة في المجال الأكاديميّ، فنراهم يجيبون على المشككين، ويردّون على حججهم تارةً، ويؤلفون بحوثا وأدلة جديدة على وجود الله تارة أخرى. من أبرز الكتب التي أصدرت مؤخرا ،كتاب Two Dozens or so Arguments for God و Reasonable Faith. وهناك أيضا كُتبًا مُبسطة لقارئ مبتدئ بالفلسفة واللاهوت مثل كتاب: مستعدون للمجاوبة لوليم لين كريج.
العقل نعمة
أريد أن أقول في النهاية، بأن العقل نعمة. إن الإله الذي يخاف من عقلي وبحثي وتشكيكي وتفكيري أو قدراتي المنطقيّة، لا يستحق عبادتي، ولا حتى يستحق أن يُدعى إلها أصلا! هل يخاف الخالق من أفكار خليقته؟ هل يخاف الحق من البحث؟ هل يخشى كمال العقل من الناقص؟ كلا، بل العكس هو الصحيح. إيماني بوجود الله، الكائن الأعظم، يدفعني ويشجعني أن أطلق العنان لعقلي، كي يسهب في التفكير، يبحث ويجتهد ليتعرّف على الله نفسه وخليقته البديعة. ويحدث ذلك إذا كنت مُتيقّنا أن عقلي هذا ليس مجرد نتيجة لتطوّر عشوائي أعمى، بل هو تصميم إلهي مُتقن ومعدٌّ لمغامرات فكريّة شيّقة ورائعة. إن وجود من صمّم هذا الكون، وضبطه بحكمته وسنّ قوانينه، حتى الفيزيائيّة منها، يدعم المشروع العقلاني والعلمي بالتحديد، إذ يعطي تفسيرًا لوجود نظام وترتيب في الكون، ورجاء لكل عقل عالِم يحاول أن يكتشف هذا النظام، فمصمّم العقل هو ذاته مُصمّم الكون، ولا بدّ أن تكون تصميمات هذا الكائن الأعظم متناغمة.
مراجع وملاحظات
[1]قد يدعي أحدهم أن الحكمة والفهم يرتبطان بكلمة الرب فقط، فإن كان ذلك صحيحًا، ألا يحل نفس هذا التفسير على “وعلى فهمك لا تعتمد”؟
[2]في هذا السياق تكلّم بولس عمّن يأكل المذبوح من أجل وثن، وعن العثرة التي يسببها للآخرين، إذ قد يفهموا من أكله أنه يوافق على معتقدات هذه الديانة الوثنية.
[3]لقد سبق وذكرت بعض الآيات، ولكني سوف أتابع النقاش في هذا الموضوع لاحقًا.
[4]وليم لين كريج، “مقابلة في كلية إمبريال لندن”. تم الاطلاع عليه يوم 1 شباط 2021. متاح على:
www.reasonablefaith.org/videos/interviews-panels/william-lane-craig-interview-imperial-college-london
[5] المرجع السابق.
[6]دالاس ويلارد وراندي فرازي، تجديد القلب (أوفير للطباعة والنشر، 2012)، 116.
[7]وليم لين كريج، مستعدون للمجاوبة (أوفير للطباعة والنشر، 2017)، 19.
[8]ليس جميع العلماء الملحدين ساخرين. بعضهم صريح بأقواله، ويقر بأن العلم لا يستطيع إثبات عدم وجود الله أو وجوده، ويعترف آخرون بأن إلحادهم لا يستند إلى العِلم.
[9]جون لينوكس، العلم ووجود الله. هل قتل العلم الإيمان بوجود الله. (خدمة كريدولوجوس، 2015)، 78.
[10] D. Hume, “Of Miracles” in his. An Enquiry Concerning Human Understanding (La Salle, Illinois: Open Court, , ([1748], 1993), section X.
[11]C. S. Lewis, Miracles (Harper One, 2015 (1947)), 62.
نشر المقال أولا في كتاب: نحو ذهن متجدد مساهمات فكرية إنجيلية في السياق الفلسطيني
رابط لمصدر الصورة.